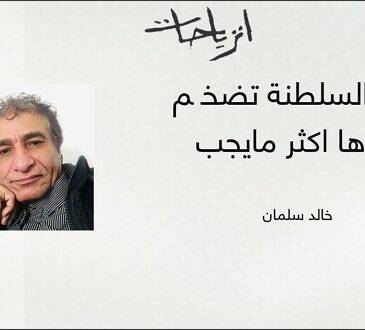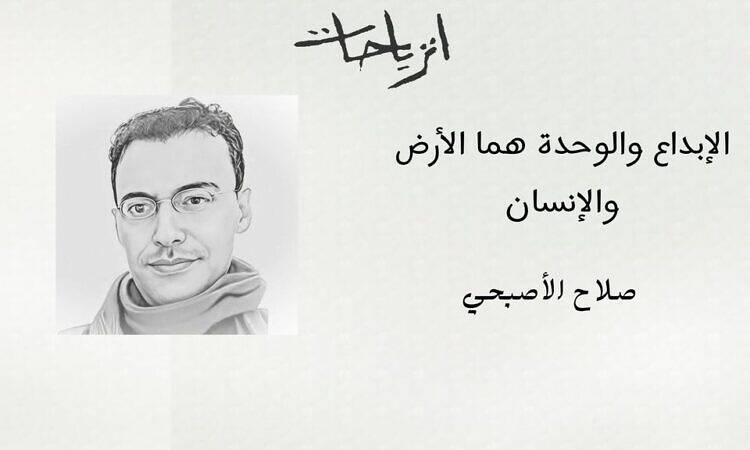
سيظل الإبداع يحظى بديمومته الوافرة في زحمة الحياة وتفاصيلها المختلفة الجوانب والمتعددة الأشكال، كمعنى لها وأيقونة تثبت أبديتها وارتباطاتها بكينونات تقابلها في الوجود وتوازيها في الصيرورة الجامعة لهما.
فاتصال الإبداع وهدفه ومنبعه وسيرة تواجده يحكمها توحّده بكيان الإنسان وحاجته أو ضرورته أو متعته أو ملازمته له كوجود يكمل وجوده، بما هو ارتباط توحد ووجود أكثر من أي شيء آخر، يظنه أي متابع أو خبير لحيثية الإبداع والإنسان، فلحظة مثول الإبداع ومفاجأة خلق الإنسان له يبرر التماهي والتمازج بينهما..
فلم ينتج الإنسان الإبداع بتباين من هنا أو من هناك بفوارق ومشاغل تهم فرداً ولا تهم آخر، وخاصة في بواكيره الأولى، كالحياة والموت، الحرب والسلم، النعيم والشقاء، الجمال والقبح، الزمان والمكان، القيمة والمتعة، الرغبة والحاجة، وإنما إنسان واحد تتساوى مشاعره وتتحد عواطفه تجاه كل هذا، لكنه خاضع للتطور والتقدم خاضع لمؤثرات كل زمن من إضافة وتكوين، ومن تراكم وتطوير وتوسع لدوائر الحياة وزيادة في الوعي واتساع في البواعث والمشاغل الإنسانية والفنية.. منذ بزوغ فجر الإبداع، الذي ظللنا نبحث عن ذلك البزوغ في أكثر من حضارة وأكثر من أمة يعتمد كلياً على التعاقبية، خاصة أن الإبداع يشترك مع الإنسان في مراحل نموه وتطوّره بتطور وعي وحضارة الإنسان ونظرته ورؤيته للحياة والعالم ولذاته بدرجة أخص، من هنا خضع الإبداع للوحدة مع حياة الإنسان وكذلك الغاية التي يتعلق بها ويتطلبها من الإبداع، ونحن نعرف من المدارس الفنية الحديثة أن نقطة الغايات والفلسفات التي يربطها الإنسان بالإبداع تختلف مع كل فترة باختلاف ثقافة وحضارة الإنسان..
حين تعيد النظر في الغايات والدوافع التي جعلت الإنسان الأول في مرحلة وجوده الأولى يحمل الإبداع غايات متحدة تخصه وتهمه بدرجة أساسية كشعور وشاغلات إنسانية سوى تعلقت بهمومه أو ببقائه أو خلاصه وفنائه.. ومن هنا جاء الإبداع كسقف آخر يحمل عن الإنسان تجلياته الحياتية وخصوصيات أمنياته النفسية والذهنية وربما تكون همومه اليومية المتواصلة مع حدوثها، وقد سجل لنا تاريخ الأدب منذ الأدب اليوناني واللاتيني والفارسي والعربي الجاهلي طوابع الاتصال بين الأدب وأنساق الحياة المختلفة بكافة مصائرها ومكنوناتها.
الأدب والثورة
نحن هنا في اليمن وبالأخص في القرن الأخير الذي حدثت فيه تحولات مختلفة في المناطق العربية كالتحرر من الاستعمار وبناء جمهوريات جديدة متحررة من التخلف والجهل، منفتحة على العصر الجديد ومعطياته المتنوعة وإمكانياته الملائمة لإنسان متحرر، يدرك معنى الحياة العادلة ومعايشة الوطن المتجمهر بتضحيات ونضالات الفن..
أي أن من قام بثورة سبتمبر 1962م كانوا هم أدباء وشعراء وفنانون حملوا على جبينهم هموم وطن وتطلعات شعب بأكمله فحرروه من براثن الظلم والقهر والجهل، بل كان هناك تحرر في الشأن السياسي وإحياء الشعر الثوري الكلاسيكي، وكيفية مساهمة هؤلاء الشعراء والأدباء بالفن في صنع وطن وبناء شعب، يحفظ لنا التاريخ شعر زيد الموشكي والحضراني والزبيري والمقالح والبردوني وأمان ومحمد عبده غانم وجرادة وكثيراً من الشعراء الذين كان لشعرهم صرخات مدوية في زلزلة الطغيان وهزّ عروشه بل اكتساح مواطنه وتوطيد حيثيات الحرية والعدالة وترسيخ قيم المدنية والعلم والمجتمع السوي.
الجميع يدرك خصوصية الأدب الفاعلة في صنع تحولات سياسية واجتماعية قادرة على النهوض بالمجتمع، بل كان الأدب هو بوابة الانتصار ونافذة كل أمل يصل إليها طموح الشعب، ورغم كل الخلافات التي كانت ماثلة بين شمال اليمن وجنوبه إلا أن الهم الوطني واحد والنضال مشترك والتضحيات متداخلة بينهما، وخير من مثل ذلك هو الأدب الذي كان يمثل النسيج الوطني الهام بين الشمال والجنوب، والمشاعر الإنسانية والنضالات هي الأخرى جسدها شاعر الشمال والجنوب بنبض وشعور واحد سواء في ثورة سبتمبر أو أكتوبر مما هيأ الظروف لتتلاقى هموهم وتفصح عن رغبتها بروح واحدة كأن لم يكن بينها فاصل أو حاجز..
لم تقف نقاط الاتصال بين الشمال والجنوب أدبياً عند هذا الحد في الاشتراك بالهم الوطني والنضال المتداخل بل تجاوزه إلى تأسيس اتحاد الأدباء والكتّاب اليمنيين في بداية السبعينيات ويضم الجميع من هنا وهناك ليثبت بقوة حميمية الأدب ورقي مسعاه وسقفه العالي في الرقي الفكري والوعي المعرفي المتجاوز لأية خلافات سياسية، مثبتاً في الوقت نفسه أن الكلمة لا يحدها برميل أو جغرافيا أو خطوط تعريفية، الكلمة إنسانية فوق كل العوائق.
ستبقى الكلمة هي الرابط الأهم في حياة البشرية ووسيلة الاتصال غير المنقطعة بين شعوب وأمم وليس بين أشطار وأقطار بل بين عصور وقرون متعددة ولغات مختلفة ومتعددة، الكلمة رسالتها عظمى وفاعليتها أكبر من حجمها أو عدد حروفها، وعمرها ما تعرف الموت أو الفناء، الكلمة هي الأبدية هي الوحدة والموحدة بين الهم الإنساني، والمتمثلة للقلق الوجودي لبني البشر جمعاء، من خلالها نتصل بماركيز وأرسطو وديستوفسكي وهاروكي وإليوت وجوته وسارتر، بها تلتقي أسماع ومشاعر الإنسان أياً كانت جنسيته أو لغته أو موطنه أو معتقده، الأهم من ذلك تتصل أرواح البشر عن طريق الإبداع الذي لا يعرف للزمان ولا للمكان سلطة عليه، ليبقى الإبداع معجزة البشر غير المنتهية.
الوحدة والشعر اليمني
من يتابع مسار الشعر اليمني منذ قيام سبتمبر وحتى عام الوحدة اليمنية 90م سيجد أن للوحدة مساحة كبيرة في جغرافيته، ونبضاً حياً في أحاسيسه بل شكلت طموحاً وتنبؤاً في تجربة الشاعر اليمني خلال تلك الفترة، حيث سعى إلى تجسيد صورتها ورسم مستقبلها وتبيان جمالها الفني والاجتماعي في تجربته، وشعوره بأهميتها وضروريتها، فكانت لا تفارق نصه ولا تبارح دلالاته، خصها بالحنين ودثرها بالشوق والتلهف لمعانقتها، بل تغنّى بها كمحبوبته وجعلها علماً في أفق خياله و طموحه.
الوحدة كانت بالنسبة للشاعر اليمني هاجساً إنسانياً، وشاغلاً فنياً يدور في فلكها ويحوم حول حماها، سعى إلى تحقيقها في نصه، وحلم كثيراً بالانتصار لمعناها، متمسكاً بجوهرها، ومدركاً لغايتها وعظمتها، نابذاً ومعادياً خصومها وأعداءها، ولم يكن الشعر الذي وهب نفسه لهذا الأمر بقليل، وإنما شعراء كثر جعلوها مبتغى فنهم، وجوهر حقيقتهم، وكانوا على يقين مطلق بحدوثها، بل إن بعضهم عاش سنوات بحلمها المتحقق، وملامستها الكامنة في صميم روحه وكلمته، و يجدر بنا في هذا المقام أن نستذكر الشاعر الذي تغنى وبشّر وحقق الوحدة في فنه، وهو الذي عاش بها سنوات عمره لكن كلماته ستخلده دهراً لا يحصيه هو ولا غيره، إنه الشاعر عبدالله عبدالوهاب نعمان الفضول، الصادح بقولها الفصل، ورغبتها الحتمية في الوجود، كما لو كان الفن هو الزمان وهو المكان، يدرك أكثر مما يُدرك.
ومن وراء هذا التسريب لمعطى الإبداع، يمكن لنا القول: إنه الوحيد الذي يجمع الشتات ويذكر بالوطن كلما تناسيناه، و يغيب الوطن عنه للحظة، ومثلما هو الإبداع وطن، يبقى مكان الإبداع هو الوطن، لذا ينبغي أن يؤدي دوره الحقيقي، ويمارس فاعليته الهامة في بث روح المودة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد، وينافي قيم الكراهية والعنف، بل وتعود تأثيراته الحميمية في المجتمع، وأن ينطلق من داخله، وأن تبقى الكلمة هي الأفق الذي يظلل الجميع، نبني أحلامنا تحتها ونطلق العنان لطموحاتنا الوطنية والإنسانية، ونبقى حالمين بمواطنة متساوية ومدنية وقيم مدنية ومشاعر إنسانية عالية.