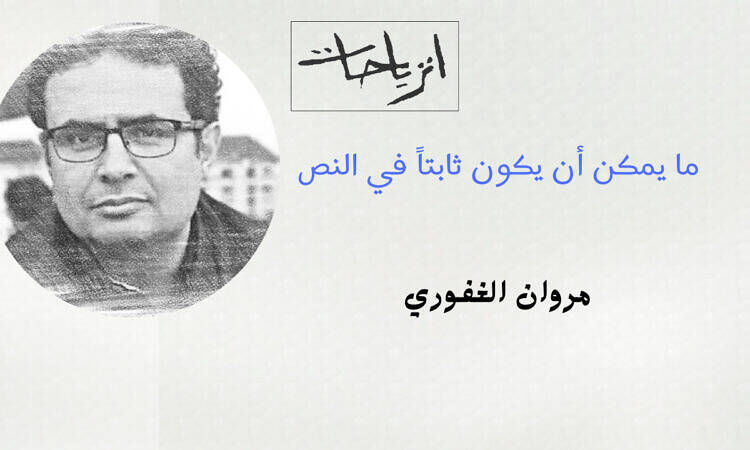
كان على “الفراهيدي” أن لا يغفل عن إدراك تفعيلة المتدارك، وأن لايدع أمراً يسيراً كهذا لخليفته الأخفش، ليحظى الأخير بنيل أسطوري على شرط الأول، رغم التزامه بآداب البنوة في إطلاق اسم “المتدارك”على بحر شعري شائع جداً.
فالبيئة الصحراوية بأبعادها الشاسعة وصوت حركة خيولها الضامرة «الوصف الأكثر شيوعاً للخيل في بادية العرب» على مدار الساعة تملأ فضاءاتها بتفعيلات الخبب «فعلن فعلن فعلن..تماماً كما تفعل حركة حوافر الناقة في رمل البادية مع تفعيلة الرجز انهما الرجز ـ الخبب الصوتان الصحراويان في القصيدة القديمة..اللازمتان الموسيقيتان لمجتمع لم تعد أسسه قائمة الآن.. تفعيلتان «بحران شعريان يتمتعان بواحدية التفعيلة تنعكسان بشكل دائم في توهجات القصيدة الصحراوية كضرب من التعبئة الموسيقية والتعبير المنطقي عن استعداد الشاعر النفسي والذهني ليبدو واحداً من أفراد هذه الصحراء بتكوينه المادي وحضوره الجماهيري مضافاً إلى تسيّده الثقافي والمعرفي إذا كان الشعر نظيراً للمعرفة والقدرة فإن ظاهرة «المعرفة والقدرة» تتجلى حتمياً كما يعتقد الشاعر القديم، في خلفية رسمية من الأداء الموسيقى الملتزم والمتماسك وبما يتناسب واشتراطات القدرة نفسها وأفق التوقع الجماهيري لأدوات وأخلاقيات المعرفة.
يحدث هذا في الزمكان الذي يحتم على الشاعر أن يلعب دوراً طليعياً يعكس من خلاله ثقافة مجتمعه ورغبته النبوئية في توسيع دائرة هذه الثقافة ايضاً ينتظم في أنساق المجتمع وتكويناته السلوكية، مبدياً استعداده فيما بعد لإدارة فتوح معرفية وحدسية بطاقات وتوهجات يمتلكها ويطوعها لمصلحة دوره الطليعي.
وهكذا وقف الحارث بن حلزة أمام الأستار السبعة لقصر المنذر متكئاً على عصا حادة اخترقت كفه اليمنى دون أن يشعر بذلك إلا بعد انتهائه من القصيدة وهو ابن المائة والثلاثين عاماً كما تروي الأسطورة، لقد بدأ واعياً في قصيدته التي نستبعد أن تكون مرتجلة كما يحب التاريخ أن يروي متحدثاً عن جدليات الصراع والانتماء وبأداء أسلوبي مجار لثقافة قومه من خلفه، وبالمعنى الثقافي ذاته «العمل الشعري الطليعي» اعتكف زهير بن أبي سلمى في سنوياته ليقول الذي لم يقل في الحكمة وفقط ليروي الآباء الكبار لصغارهم عن عبقرية الحكيم المسن ومشاهداته في الحياة والإنسان.
لقد كانت المشافهة هي الوسيلة الواحدية للتواصل وكان التلقي السماعي هو المعبر المعرفي الوحيد ايضاً وفي «مكان» لايوفر غير هذه القناة الضيقة كنمط مفرد من أنماط المثاقفة، كان على الشاعر أن يحاول جاهداً لكي يبدو شخصية جماهيرية يصدر عن الحاجة والتطلع القومي يحدث هذا حتى في اللحظة التي يخفت فيها الحس القومي والهم الطليعي في ذات الشاعر المتفردة وغير المستقرة، فقط لأن شرط التلقي كان متطابقاً تماماً مع أفق التوقع الجماهيري مع الحاجة الجماهيرية للاستئناس بالشعر المعرفة والقدرة وإثارة الكبرياء القومية والشعور النبيل بالتفرد عن الآخر «القبائل، الأسواق، الحضر، العدو» كأنما كان عليه في قضاء ضيق كهذا أن يعزي نفسه بأحاديث When in Rome do as the Romans do
وعندما زحفت الصحراء على المدينة وبشكل خاص: عندما نبتت السيوف العربية في حدائق اسبانيا «الأندلس..» كانت أدوات الإنتاج قد تغيرت كثيراً، إن لم يكن: تماماً مضافاً إلى تغير المكان والتكوين الاجتماعي المتوارث والمتوالد، واكتساب مهارات تلقي وتعلم جديدة، التعلم الذاتي من خلال القراءة والكتابة كوسيط معرفي ناشئ: بالإضافة إلى مهارات الكسب المعرفي النمطية: المحاكاة simulation والتعلم التعاوني collahorative والتلقين instructed learning النشوءات الجديدة فقد كان على كثير من شروط ماقبل القصيدة أن تسقط تحقيقاً للمبدأ الثقافي الصحراوي نفسه القائل: الشعر ابن المكان ونحو من هذا هو ماحدث بالفعل مع النص الشعري الأندلسي ، لقد تغيرت العادة الشعرية بمعادلاتها وتفاعلاتها وانتهى الشاعر إلى قناعة تامة بأن عليه أن يجلس الآن القرفصاء أو على أي هيئة يحب فقد ظل واقفاً على قدميه لأكثر من 1500عام ملتزماً بحتمية اجتماعية صارمة، «لايلقي الشاعر إلا واقفاً» عقيدة التزم بها الشاعر كمجلي إضافي من مجنات إيمانه بأخلاقيات المعرفة والقدرة «التفسير الظاهراتي للشعر» إمعاناً في الالتزام المعياري الجماعي.
وأياً كان الموقف الآن من فكرة “طليعية الأداء الشعري”فإن مايهم أكثر هو ملاحظة الموقف الواعي للشاعر القديم ذي الخلق الإرادي والمدرك تماماً لجملة المعنى الاجتماعي المجايل له وبحيودات لافتة، فقد تطور ذلك الوعي من مرحلة المهادنة والمجاراة لأعراف المجتمع واستعدادته الثقافية، كخدمة أدبية ضمن السلك الاجتماعي والمصلحة القومية، إلى الصعلكة كظاهرة جديدة أفرزتها حاجة اجتماعية ملحة نشأت هي الأخرى من منطقة التكوينات الأدنى في المجتمع “الفقراء، الأسرى، ضحايا الحروب، ضحايا القانون الاجتماعي”.
لقد شكل الزمكان والاجتماع داسرات أبدية لماكنة الشعر كأصول ثابتة بخطوط عامة مراوغة وغير مستقرة في جملة معادلاتها التكوينية وهو مالم يفهمه الكثيرون من المتسلقين على القصيدة قديماً وحديثاً وإذا كنا نجد شاعراً كبيراً كأبي العلاء المعري «ت 449هـ» يكتب في «حديث الحيتان» بأداء أسلوبي يخترق الوعي الجماعي السائد ونظرته إلى السطح الخارجي للقصيدة، وليقدم لغة خفيفة متوهجة:
وقالت الحيتان المتفككة:
ماحدث نضوب الماء إلا لخطب.
فمن هذا الرجل الصالح الذي عمل خيراً في الصرعين ودأب في صلاح الشرعين.
فإن أبا العلاء كان يتقدم ليفتح دائرة جديدة في الوعي الجماعي، طارحاً رؤية شعرية، من خلال أكثر من نص متحرر عن أعراف الأداء الشعري المتداولة، لاتقدس الموروث ولاتعاني من أزمة..«أصولية الانشداد إلى المستقبل» كما تفعل غالبية الرؤى الحداثية المتشنجة في اللحظة الراهنة، لقد كان عليه أن ينحي العقيدة المجازفة لقدامة بن جعفر «الشعر كلام موزون» وإن كان لم يسم ماكتبه في «الحيتان» و«الربيعان» شعراً ليجعل من الزمكان والاجتماع أصولاً شعرية ثابتة بتكوينات داخلية مراوغة إلى مالانهاية.
وكما فعلت أجيال واسعة من شعراء مابين القرنين: الخامس والرابع عشر الهجري بالتزامهم المهذب بالهيئة الشعرية، قرابة ألف سنة من المحاكاة غير المدركة لمعادلات ماقبل النص الشعري بالأبعاد الزمكنية والسوسيولوجية فإن كثيرين يفعلون الآن وأكثر من كثيرين مع النص الجديد هكذا وبهذه الجاهزية النمطية، يغفل غالبية شيعة و”آل بيت” النص الجديد، كأسلافهم من سدنة النص القديم، الشروط الثقافية وجوهر التكوين الاجتماعي وحداثية اللحظة الزمنية بطاقاتها وإمكاناتها التطورية في مقارباتهم النقدية وأدائهم الشعري..إنهم يتجاوزون انعكاس ذلك كله في المعادلة الشعرية برمتها وإذا كان لابد من حديث عن أصول شعرية فإن “الزمكان والاجتماع البشري”هي الأصول الشعرية الحقيقية وليس الشكل الشعري أو السلالة القبلية.. إن هذا الثالوث “الزمكان والاجتماع” هو الفاعل الجوهري في تطور الوعي البشري العام وتغير وسائله التعبيرية، بما يفرزه من ثقافات جديدة وأدوات إنتاج جديدة واستعدادات نفسية مختلفة وتكوينات اجتماعية sociogenesis مطردة و..إنسان جديد يختلف بكل تأكيد عن الطفل البريء صاحب المخيال الأفقي والإنسان الجنوبي غير المكتمل.


